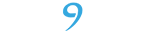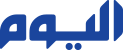يقول العالم الفيزيائي صاحب نظرية النسبية ألبرت أينشتاين: “لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، لكني أعرف أنه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية الرابعة”. وإذا كان أينشتاين قد قال ذلك قبل وفاته في عام 1955م، فإننا اليوم أمام هذا السلاح الذي سيستخدم في تلك الحرب العالمية الثالثة، والذي سيكون كفيلاً بإعادة البشر إلى نقطة الصفر – كما توقع ذلك العالم الشهير -؛ أي العودة إلى سلاح (العصا والحجر).

إننا إزاء سلاح يأخذنا إلى آفاق بعيدة من الحيرة والقلق، ويلقي بنا في غياهب الرهبة والخوف مما يمكن أن تصنعه يد الإنسان بنفسه؛ لتنطبق عليه المقولة الشهيرة: “بيدي لا بيد عمرو”.
تكمن خطورة هذا السلاح في أنه يرتدي ثياب الخير، ويسير مبتسماً، بينما يخفي تحت هذه الثياب، وخلف تلك الابتسامة، خنجراً فتاكاً يغتال كل مَن يواجهه!
إنه سلاح الدمار الشامل الأكثر براءةً وفتكاً في الوقت ذاته، إنه الكيمتريل، فما هو الكيمتريل؟ وكيف جمع بين الخير والشر؟ وما واقع الصراع المحتدم بشأن استخدامه وامتلاكه؟ وما حقيقة نظرية المؤامرة التي تدور حوله؟ هذه الأسئلة وغيرها ستجيب عنها بشيء من التفصيل السطور التالية.
إذا كانت بعض القوى العظمى تأخذ العالم إلى طريق حظر الأسلحة النووية؛ بوصفها السلاح الأخطر القادر على إبادة الجنس البشري، وتعمل تلك القوى ليل نهار من أجل أخذ العهود والمواثيق الكفيلة بإخماد هذا السلاح في غمده؛ فإن بعضها يعمل في الخفاء على تطوير سلاح آخر أكثر فتكاً وتدميراً، خلف ستار (خدمة الإنسانية).. إنه غاز الكيمتريل.
قصة اكتشافه
تتكون تسمية الكيمتريل من مقطعين أولهما Chem أي مواد كيماوية، والآخر trail أي الأثر، وهي اختصار لعبارة chemical trail أي أثر أو مسار المواد الكيماوية، والتي تشمل: المعادن الثقيلة، ومنها الألومنيوم والباريوم، وكذلك الأملاح، ومنها الماغنسيوم والكالسيوم، إضافة إلى استخدام عناصر أخرى مثل التيتانيوم وألياف البوليمر المجهرية.
ويرجع تاريخ غاز الكيمتريل Chemtrail إلى عقد التسعينيات من القرن الماضي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعالم الصربي نقولا تسلا مؤسس علم الهندسة المناخية الذي كان يعيش حينها في ربوع الاتحاد السوفييتي قبل انهياره، والذي اكتشف مجال الجاذبية المتبدل، وكيفية تأيين المجال الهوائي للأرض باستخدام شحنات من موجات الراديو؛ مما يؤدي إلى حدوث أعاصير اصطناعية قوية. وكان تسلا يهدف إلى استخدام هذا الاختراع في الكثير من الأغراض السلمية المرتبطة بتغيرات البيئة والطقس والمناخ، وأظهر نموذجاً من نجاحه في ذلك مع بدايات القرن الحادي والعشرين، من خلال تجارب عدة لاستمطار السحب، أتبعها بنجاح آخر في شهر مايو من عام 2005م، عندما استطاع أن يستخدم هذا الغاز في إحداث ظاهرة اصطناعية تمثلت في تشتيت السحب التي كانت تخيم على الميدان الأحمر خلال أحد الاحتفالات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، وذلك برش هذا الغاز في سماء العاصمة موسكو.
وكشف هذا الاستخدام الذي حوَّل الأجواء الغائمة إلى مشمسة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الغاز؛ فقد تبين أن الصين استخدمته بين عامي 1995 و2003م؛ لاستمطار السحب فوق نحو ثلاثة ملايين كيلو متر مربع من المناطق الجافة، وقد ساعدها ذلك في الحصول على كميات كبيرة من المياه تجاوزت مئتي مليار متر مكعب كانت كفيلة بري تلك المساحات الشاسعة التي تعادل ثلث مساحة الصين، ولتجني 1,4 مليار دولار مقابل تكلفة لم تتجاوز 265 مليون دولار.
هاتان صورتان مشرقتان لبعض الاستخدامات السلمية لهذا الغاز الذي يتكون من مركبات كيماوية يمكن رشها على ارتفاعات جوية محددة لاستحداث ظواهر طبيعية يستفيد منها الإنسان في أغراض شتى، منها – كما رأينا – استخدامه في إحداث ظاهرة الاستمطار فوق الأراضي التي تعاني الجفاف، وذلك باستخدام خليط من مركب أيوديد الفضة مع بيركلورات البوتاسيوم يُرش فوق السحب؛ فيثقل وزنها، ولا يستطيع الهواء حملها؛ فتسقط أمطاراً. كما أنه يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد بغرق الجزر وانتشار الفيضانات والأعاصير، ولا تزال قضية العصر في مجال المناخ والبيئة، ويتمثل إسهامه في الحد من هذه الظاهرة بإضافة جزيئات دقيقة من أكسيد الألومنيوم التي تعمل كمرآة تعكس أشعة الشمس فتنخفض درجة حرارة الهواء ونسبة الرطوبة على الأرض.
الوجه الآخر
يتفق غاز الكيمتريل مع الطاقة النووية في أن كليهما يجمع بين الأغراض السلمية والحربية، ولكن تكمن الخطورة الأكبر للكيمتريل أنه يظهر للإنسان مرتدياً زي الظواهر الطبيعية؛ فهو يرتدي مرةً قناع الزلازل، وتارة يأتي على شكل أعاصير، وتارة أخرى يوهمنا بأنه برق ورعد وعواصف. وهنا يقف الإنسان حائراً ومتسائلاً: هل هذه الكارثة التي حلت بالأرض طبيعية أم صناعية بفعل فاعل؟ وهنا يطل الكيمتريل بوجهه الآخر؛ بوصفه أحدث أسلحة الدمار الشامل، وأداة للعبث مع الطبيعة، والتلاعب بالمناخ، ومحاولة خبيثة لامتلاك الطقس، إن صح التعبير.
ويبدأ رسم ملامح هذا الوجه الآخر عندما ترش إحدى الطائرات غاز الكيمتريل في الهواء، فيشكل سحابة من الغبار الدقيق لأكسيد الألومنيوم الذي يعمل كمرآة عاكسة للأشعة؛ فيحجب أشعة الشمس عن الأرض، وعندها تنخفض درجات حرارة الجو إلى نحو سبع درجات، وتهبط نسبة الرطوبة إلى 30 في المئة؛ نتيجة امتصاص أكسيد الألومنيوم المتحول إلى هيدروكسيد ألومنيوم. ونتيجة لهذه التغيرات يحدث انخفاض شديد لدرجات الحرارة، وانكماش حجم الكتل الهوائية التي تغطي مساحات تقدر بملايين الكيلومترات، وهو ما يؤدي إلى تكوين منخفضات جوية في طبقة الغلاف الجوي (الاستراتوسفير)؛ فتندفع إليها الرياح من أقرب منطقة ذات ضغط جوي مرتفع ثم من المنطقة التي تليها؛ مما يؤدي إلى تغيير المسارات المعتادة للرياح، وتفقد السماء لونها؛ لتصبح أثناء النهار ذات لون رمادي خفيف يميل إلى اللون الأبيض، وفي المساء تبدو لون السحب الاصطناعية بلون يميل إلى الرمادي الداكن. ونتيجة لهذا تحدث تغيرات غير مألوفة في الطقس ينتج عنها حدوث صواعق وبرق ورعد وجفاف في تلك المناطق، كما ينخفض مدى الرؤية، مكونةً ما يُعرف مناخياً بـ(الشبورة)، وذلك بسبب العوالق الكيماوية للمكونات الهابطة على الأرض.
هذا الوجه الآخر رصده خبراء حماية البيئة في كثير من الدول، منها: كوريا الشمالية، وأفغانستان، وكوسوفو. ومن أبرز هؤلاء الخبراء العالم الكندي ديب شيلد الذي عمل فترة من حياته في مشروع الدرع الأمريكي، والذي شن حملة عام 2003م للدعوة إلى الاقتصار على الاستخدام السلمي لغاز الكيمتريل، وعدم العمل على تطويره لأغراض حربية.
ومن أفضل مَن كتب عن هذا الوجه القبيح لغاز الكيمتريل أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة في كلية الزراعة بجامعة القاهرة الدكتور منير محمد الحسيني؛ ففي بحث له نشرته صحيفة (الأهرام) المصرية، أوضح أن الكيمتريل الذي جرى رشه فوق أجواء كوريا الشمالية أدى إلى تحول الطقس هناك إلى طقس جاف، وإتلاف محصول الدولة الرئيس وهو الأرز، كما أدى بشكل تدريجي إلى وفاة الآلاف شهرياً. كما أوضح أن هذا السلاح تم استخدامه في منطقة تورا بورا الأفغانية لتجفيفها ودفع سكانها إلى الهجرة أثناء الحرب على تنظيم القاعدة. كما رجح أن يكون رش سحابات الكيمتريل هو السبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة في مصر وشمال إفريقيا وبعض البلدان العربية، وأنه السبب في موجات الحر القاتلة ببعض البلدان الأوروبية.
كما تطرق الحسيني إلى صورة أخرى لهذا الوجه، وهو الصواعق، موضحاً أنها أحد الآثار الجانبية لرش الكيمتريل من طبقة التروبوسفير واتحاده مع أملاح وأكسيد الباريوم وثاني أكسيد الكربون؛ مما يؤدي إلى توليد شحنات في حقول كهربائية كبيرة، و”عندما يتم إطلاق موجات الراديو عليها لتفريغها تحدث الصواعق والبرق والرعد الجاف دون سقوط أي أمطار، ضارباً مثلاً لذلك بما حدث في بازل بسويسرا، وولاية ألاسكا الأمريكية، ومصر”.
ومن أعراض إصابة الإنسان بهذا الغاز: نزيف الأنف، ضيق التنفس، آلام الصداع، عدم حفظ التوازن، الإعياء المزمن، أوبئة الأنفلونزا، أزمة التنفس، التهاب الأنسجة الضامة، فقدان الذاكرة، وأمراض الزهايمر المرتبطة بزيادة الألومنيوم في جسم الإنسان. وفي هذا الصدد أشار أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة في كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى أن بعض شركات الأدوية الكبرى تحرص على تمويل أبحاث تطوير الكيمتريل؛ “لأنه مع انتشار الآثار الجانبية لرش الكيمتريل على مستوى العالم ستزداد مبيعات هذه الشركات العملاقة جراء بيع الأدوية المضادة لأعراضه”!
واقع الصراع
يشير تاريخ الكيمتريل بدءاً من اكتشافه إلى ما آل إليه اليوم من استخدامات وما يُجرى عليه من تجارب إلى أن الصراع حوله لم يعد ينحصر بين القوتين العظميين سابقاً (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا)؛ إذ روسيا تمتلك هذا السلاح بحكم أنها موطن الاكتشاف، بينما أمريكا اليوم تعمل بدأب على تطويره، بعدما حصلت على كلمة السر من صاحب الاختراع شخصياً (نيقولا تسلا) الذي هاجر إليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؛ فساعد بلاد العم سام على تطوير أبحاث الكيمتريل؛ فتوصلت إلى بعض القواعد والتطبيقات التي تتيح تحويله إلى سلاح يمكنه إحداث زلازل وأعاصير اصطناعية مدمرة باستخدام تقنيات استحداث الضغوط الجوية العالية والمنخفضة.
ويضاف إليهما بريطانيا التي تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة في برنامج (هارب)، وهو برنامج أبحاث عن الغلاف الأيوني يتم بتمويل مشترك بين القوات الجوية والبحرية الأمريكية وجامعة ألاسكا. ويعمل البرنامج على تحليل الغلاف الأيوني، وتطوير تقنية المجال الأيوني، من خلال محطة هارب التي بُنيت على موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من منطقة جاكونا بولاية ألاسكا. ويشمل عمل البرنامج إرسال ترددات لاسلكية عالية القوة لإثارة وتنشيط منطقة محدودة من المجال الأيوني بشكل مؤقت، وكذلك دراسة العمليات الفيزيائية التي تحدث في تلك المنطقة المتأثرة؛ وهو ما دفع بعض الجهات إلى اتهام البرنامج بالتسبب في وقوع بعض الكوارث الطبيعية التي شهدها كوكب الأرض.
كما كشف تقرير لمجلة (العلم والسلاح) الأمريكية، أن علماء المناخ الإسرائيليين تمكنوا من تطوير هذا السلاح، واستطاعوا تزويد بعض الطائرات النفاثة بمستودعات لهذا الغاز يمكنها رشه بواسطة مضخات ذات ضغط عال وُضعت على الحافة الخلفية لأجنحة الطائرات فوق فتحة خروج عادم الوقود.
ولا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى الصين التي تستخدم هذا الغاز – كما أشرنا سابقاً – في مجال استمطار السحب؛ وبالتالي يمكن استخدامه في أغراض أخرى.
وترسم هذه الأطراف جانباً من الصورة التي قد يشكلها الصراع على هذا السلاح ذي الحدين، والذي يرى كثير من خبراء الهندسة المناخية والبيئية – منهم الكولونيل تامزي هاوس أحد جنرالات الجيش الأمريكي – أن صورته لن تكتمل قبل عام 2025م، وهو الوقت الزمني المحدد لاكتمال التجارب على هذا السلاح الجديد الذي سيمكنه حينها التأثير في طقس أي منطقة بالعالم. وفي هذا المضمار قطعت الولايات المتحدة شوطاً كبيراً عندما بادرت عام 2000م إلى الحصول على موافقة الأمم المتحدة على استخدام هذا الغاز؛ من أجل خفض مستوى الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، متعهدةً بتمويل المشروع كاملاً، ومتكفلةً بنشر طائراتها المدنية النفاثة في كل أرجاء العالم؛ تمهيداً لرش الغاز المكافح لظاهرة الاحتباس الحراري.
نظرية المؤامرة
تشير الكثير من التقارير المتخصصة والأدبيات العلمية إلى أن بعض الدول التي تمتلك هذا السلاح قد ارتكبت – بقصد أو من دون قصد – بعض الأخطاء الجسيمة في التعامل مع هذا السلاح، من خلال التأثيرات الجانبية التي خلفها رش الغاز في بعض الدول.
ويمكن إدراج كل ما تداولته هذه التقارير تحت مفهوم (نظرية المؤامرة) التي تنظر بعين الريبة والشك إلى وقوع الكثير من الكوارث الطبيعية بطريقة غريبة، وفي أماكن غير متوقعة، وفي ظروف تتناقض مع قوانين الطبيعة؛ لذلك يتهم أصحاب هذه التقارير بعض الدول بالوقوف خلف هذه الكوارث التي راح ضحيتها الآلاف من البشر والكائنات الحية، والتي تسببت في الإخلال بموازين الطبيعة؛ وبالتالي تدمير حياة الإنسان.
خالد أبا حسين